بعث الأنبياء
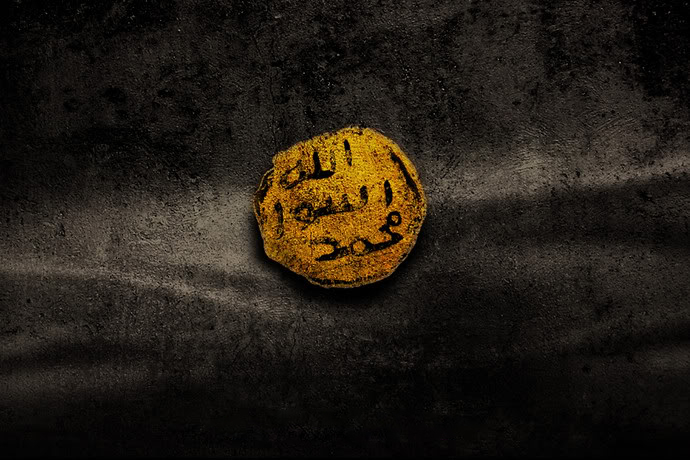
مصطفى آل مرهون
(هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانو من قبل لفي ضلال مبين) الجمعة: ٢.
شهدت الأرض مايقارب اربعة وعشرين ألف نبي، والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا بعث الله الأنبياء والرسل؟. ذكر العلماء للإجابة على هذا السؤال عدة نقاط. النقطة الأولى: أن الله سبحانه لم يكن لاغيا في خلقه ولا عابثا في إرادته، وإنما خلقهم لمصالح تعود إليهم، وهو الغني عن عباده، والغني لا يفتقر إلى غيره، فيما هو غني فيه، ولا بد من إرشادهم لتحصيل تلك المصالح المترتبة على وجودهم، ولايتم ذالك إلا بواسطة من يختاره الله سبحانه لأداء تلك المهمة، (والله أعلم حيث يجعل رسالته)، وبعد أن خلقهم لمصالح تعود إليهم، ولم يكن العقل كافيا في إدراك الحسن والقبح في جميع الأفعال، وإنما يدرك حسن بعض الأفعال وقبح بعضها، ولا طريق إلى معرفة ذالك إلا بواسطة الرسول المبلغ عن الله سبحانه.
النقطة الثانية: أن الله كلف العباد بعبادته، وأراد منهم مايقربهم إليه، قال سبحانه: (وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) وفي الحديث القدسي: (كنت كنزا مخفيا، فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف) ووصف سبحانه نفسه باللطف في قوله تعالى: (الله لطيف بعباده) ولا يمكن التوصل إليه ليعملوا بما يريد، ويتجنبوا ما يكره، قال تعالى: (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه مايشاء إنه علي حكيم) الشورى: ٥١. فإذا كان الهدف والغاية من الخلق هو معرفته وعبادته، فلا بد من إرسال الرسل. النقطة الثالثة: دليل اللطف. وهو مايكون المكلف معه أقرب إلى الطاعة، وأبعد عن المعصية، والرسول تتحقق به تلك الفائدة، فيجب على الله سبحانه، وإلا كان العقاب منه قبيحا، وقد حكى الله سبحانه ما يمكن أن يجري على لسان عباده، لو أنه عذبهم قبل إرسال الرسل إليهم بقوله تعالى: (ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالو ربنا لو أرسلت إلينا رسولا ) فأخبر أنه لو لم يبعث الأنبياء، لكان لهم الإحتجاج، وليس لهم ذالك إلا إذا كان عقابهم قبيحا.
وقوله تعالى: (في الأميين) المراد بهم العرب، ووصفهم بالأميين؛ لأن أكثرهم آنذاك لا يقرأ ولا يكتب، وذهب البعض إلى أن المراد (بالأميين) : أهل مكة؛ لأن أم القرى من أسمائها. ويرد هذا القول أمور: الأمر الأول: أن المتبادر إلى الأذهان من هذه الكلمة: عدم القرآءة والكتابة. الأمر الثاني: قوله تعالى: (ومنهم الأميون لا يعلمون الكتاب). الأمر الثالث: قول الرسول (ص): (نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب). الأمر الرابع: إنه لا يناسب كون السورة مدنية، لإيهامه كون الضمير في: (يزكيهم ويعلمهم) راجع إلى المهاجرين، ومن أسلم بعد الفتح وأخلافهم، وهو بعيد عن مذاق القرآن. وفي تفسير القمي، عن الصادق (ع): (كانوا يكتبون، ولكن لم يكن معهم كتاب من عند الله، ولا بعث إليهم رسولا، فنسبهم الله إلى الأميين. وفي مجمع البيان قوله: أميون: جمع أمي. والأمي في كلام العرب: الذي لا كتاب له من مشركي العرب. وقيل: هو نسبة إلى الأم؛ لأن الكتابة مكتسبة فهو على ما ولدته أمه من الجهل بالكتابة. وقيل: نسبة إلى أمة العرب؛ لأن أكثرهم أميون، والكتابة فيهم عزيزة أو عديمة، فهم على أصل ولادة أمهم.
وزعم بعض أهل الكتاب، أن قول الله تعالى: (في الأميين) أنه أرسل للعرب فقط، ولا تتعدد رسالته في غيرهم.
والجواب:
إن هذا أخذ ببعض الكتاب فإن الله يقول: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) وقال تعالى: (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون) ومصدر القرآن واحد يفسر بعضه بعضا،
ويتضح من هذا الزعم وجه المغالطة ودس الشبهات، الذي يظهره البعض على الإسلام والمسلمين، ولو أن الإسلام يرحب بكل دارس منصف إذا كان مؤهلا ومحيطا بكل جنبات البحث والموضوع.
(رسولا) لقد وصف الله تعالى السفراء العظام بوصف الإمامة بقوله تعالى: (إني جاعلك للناس إماما) وبالخلافة في قوله تعالى: (إنا جعلناك خليفة في الأرض) وبالرسالة في قوله تعالى: (وسلام على المرسلين) وبالنبوة في قوله تعالى: (فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين) ولم يصفهم بوصف الحاكمية، لا بمعناها القانوني ولا السياسي؛ لأن النبي والرسول ليس حاكما أعلى وإنما هو نائبه وهو الله سبحانه.
ومع تعدد الأوصاف المشار إليها فقد اقتصر القرآن الكريم في خطاب محمد (ص) على صفة الرسول. قال تعالى: (يا أيه الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك..) وعلى صفة النبي. قال تعالى: (يا أيه النبي حسبك الله) فهل هما بمعنى واحد أم هناك فرق بين الوصفين؟ وإذا لم يكن بالنسبة للنبي بعتبار أن هذا الوصف جامعا لهما، فهل يتجلى في من سبقه؟
الجواب: لقد اختلفت الوجوه في ذالك، ومما قيل: إن النبي هو الإنسان المخبر عن الله بغير واسطة بشر وأعم من أن يكون له شريعة، كمحمد (ص) أو ليس له شريعة، كيحيى (ع) وإنه إنما سمي نبيا؛ لأنه إنما أنبأ عن الله تعالى، أي أخبر عنه. والرسول هو المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر وله شريعة، وهكذا يظهر أن كلا من النبي والرسول متساويان في صفة الإخبار عن الله تعالى، ولكن الرسول له ميزة خاصة هي ميزة الإرسال بشريعة، أما النبي فهو أعم من حامل الشريعة أو القيم عليها بعد وفاة حاملها، ومن هنا قال المتكلمون: إن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول.
(منهم) أي من الأميين. وهل كان النبي (ص) أميا، وما معنى ذالك؟ قال الزجاج: معنى الأمي: الذي هو على صفة أمة العرب. قال الرسول (ص): (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب) والنبي كذالك. قال أهل التحقيق: وكونه أميا بهذا التفسير، هو من جملة معجزاته، وبيانه من وجوه:
الوجه الأول: إن النبي كان يقرأ عليهم كتاب الله منظوما مرة بعد أخرى، من غير تبديل ألفاظه ولا كلماته، والخطيب من العرب إذا ارتجل خطبة، ثم أعادها فإنه لا بد أن يزيد فيها أو ينقص، ثم إنه (ص) مع إنه أمي يتلو كتاب الله من دون تغير فكان ذالك من المعجزات (سنقرئك فلا تنسى).
الوجه الثاني: إنه لو لم يكن أمي لصار متهما، في أنه طالع كتب الأولين، فحصل هذه العلوم من تلك المطالعة، فلما جاء بالقرآن من غير ذالك كان الأمر معجزا، وهذا هو المراد من آية: (وماكنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لرتاب المبطلون).
الوجه الثالث: إن تعلم الخط شيء سهل، فإن أقل الناس ذكاء وفطنة، يعلمون الخط بأدنى سعي، فعدم تعلمه يدل على نقصان عظيم في الفهم، ثم إنه تعالى، آتاه علوم الأولين والآخرين، وأعطاه من العلوم والحقائق، مالم يصل إليه أحد من البشر، ومع تلك القوة العظيمة في العقل والفهم، جعله بحيث لم يتعلم الخط الذي يسهل تعلمه، على أقل الخلق عقلا وفهما، فكان الجمع بين هاتين الحالتين المتضادتين، جاريا مجرى الجمع بين الضدين، وذالك من الأمور الخارقة للعادة، وجار مجرى المعجزات.
ولم يعرف عن الرسول (ص) أنه كتب بعد النبوة إلا إنه وقع كما روي عنه (ص) لذالك وضع له كتابا للوحي والمراسلات، ومن أكبر كتابه علي (ع) وشاء بعض الناس أن يكون معاوية هو كاتب الوحي، ويكفينا هنا كلمة علي (ع): (حطني الدهر حتى قيل علي ومعاوية) ولم يرضى معاوية بأن يكون نظيرا لعلي حتى كان يشتمه على المنابر، وجعل شتمه كلمة باقية في عقبه، حتى قال يزيد للسيدة زينب(ع): إنما خرج من الدين أبوك. قال الشاعر:
أعلى المنابر تعلنون بسبه *** وبسيفه نصبت لكم أعلامها



