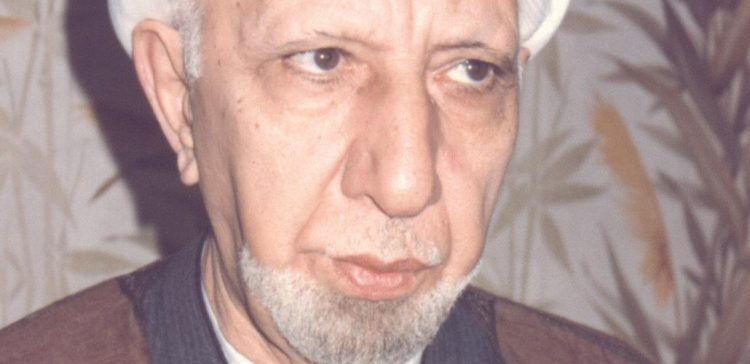كشكول الوائلي _ 87

السجاد وطاووس اليماني
فأدعية الصحيفة السجادية كلّها تصب في مجال التعلّق الروحي بالله عزّ وجلّ والخوف منه، ونقل الإنسان إلى عالم ما وراء الطبيعة، وشرح ما ينبغي أن يكون عليه العبد من الأخلاق والانقطاع إلى اللّه، وتذكيره بالآخرة والموت، « وكفى بالموت واعظا »[1]، يقول طاووس اليماني: كنت أطوف بالكعبة في جوف الليل، فأقبل رجل قد أكربته أحزانه وأقلقته أشجانه، فدخل إلى الكعبة ورمق السماء بطرفه، وسمعته يقول: « إلهي، وحقّك ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بنكالك شاك، ولا لعقوبتك متعرّض، ولكن سوّلت لي نفسي وغرّني سترك المرخى علي، فأنا الآن من عذابك مَن يستنقذني؟ وبحبل مَن أعتصم إذا قطعت حبلَك عني؟ فواسوأتاه غدا من الوقوف بين يديك إذا قيل للمخفّين: جوزوا، وللمثقَلين: حطّوا. ليت شعري، أمع المثقلين أحطّ، أم مع المخفّين أجوز؟ ما لي كلّما طال عمري كثرت خطاياي، أما آن لي أن أستحي من ربي؟ ». يقول طاوس: ثم سقط فأقبلت إليه، فرأيت شفاهه تتمتم بهذين البيتين:
«أتُحرقُني بالنار ياغايةَ المُنَى *** فأينَ جزائي ثمَّ أينَ محبّتي
أتيتُ بأعمالٍ قباحٍ زريّةٍ *** وما بالورى خلقٌ جنى كجنايتي»
فجلستُ عنده أمسح التراب وحبات العرق عن وجهه، فانتبه لي فقال: «من؟ طاووس هذا؟». قلت: نعم، فداؤك طاوس، هذا أنت وتصنع هذا؟ قال: «ولماذا؟». قلت: سيدي، من ورائك شفاعة جدك ونسبك، ثم إنك محسن ورحمة اللّه قريبة منك. فالتفت إليَّ، وقال: «دع عنك حديث أبي واُمي، ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَتَسَاءَلُونَ [2]﴾ ». ثم قال لي: « دعني أدنُ إلى الله ». قلت: تدنو إلى اللّه وأنت زين العابدين؟ قال: «نعم، لا تحُل بيني وبين ربي». فأضجعته وقمت عنه[3].
هل تدخل طاعة الوالدين في باب التزاحم؟
ويعالج الفقهاء هذه المسألة في باب التزاحم، فاللّه أمرنا بإطاعة الوالدين، بشرط ألاّ تسبّب معصية للّه، فلو فرضنا أن طاعة الأبوين لا يمكن اجتماعها، كأن يقول لي أبي: ادرس في هذه المدرسة، وتقول اُمي: لا. فهنا لا يمكن أن أجمع بين الأمرين، ويحصل التكاذب في أصل الجعل على حدّ تعبير الفقهاء ـ أي أن الدليل الذي يأمرني بطاعة الأبوين يحصل فيه التكاذب ـ فكيف يقول لي اللّه: أطعهما، ثم لا يمكن أن تجتمع طاعتهما؟
في مثل هذه الحالة يقول الفقهاء: إن كان هناك مُرجِّح قدّمناه، فتصبح المسألة من باب التزاحم، وللتزاحم شروط لا مجال لذكرها الآن. ومن الأمثلة على التزاحم والترجيح أنني مثلاً أكون مأمورا بصلاة واجبة واُخرى استحبابيّة في وقت واحد، وكان وقت الواجبة مضيّقا، ووقت الاستحبابيّة موسّعا، واجتمعت الصلاتان في وقت لا يمكنني فيه أن أجمع بينهما، فعندئذ اُقدّم الصلاة الواجبة، لأهمّـيّـتها. وهنا يتّضح عندنا معنى المرجّح.
وفي مسألة الاُمّ والأب يقول الفقهاء: عند عدم وجود المرجّح فرأي الاُمّ أهمّ، وأمرها مقدّم على أمر الأب. وهذا عين الحقيقة، لأنك تلمس بصمات الاُمّ واضحة على أي جيل من الأجيال. ويقسم علماء الاجتماع المجتمع إلى قسمين: مجتمع ينسب إلى الاُم ومجتمع ينسب إلى الأب، ففي بعض المجتمعات يطغى الأب على الاُسرة وفي بعضها تطغى الاُمّ، وفي بعضها يحصل توازن بين الطرفين. فالمشرّع الإسلامي يعطي الأهمّـيّة للاُمّ حسب القاعدة التي تقول: الغُنم بالغُرم[4]. فمن يخسرْ أكثر يأخذ مقابل خسارته، والاُمّ هي التي تخسر أكثر. فالأب يحمل ابنه خفيفا ولا يشعر به، والاُمّ تحمله ثقيلاً وكأنها تحمل جبلاً[5] خصوصا من تصل منهن إلى عشرة أشهر. وناهيك عن ساعة الوضع والولادة.
يقول الإمام مالك في رأي يتفرّد به عن المذاهب الإسلاميّة الاُخرى كلها: إذا بلغت الاُمّ ستّة أشهر في الحمل لا تنفذ تصرّفاتها المالية. والسبب في ذلك أنها أشبه بالمريض مرض الموت الذي لا يُعطى الحق في التصرّف بأمواله ؛ لأن ملكيّته أصبحت متزلزلة فتنتقل لأولاده. وعندما تصل الاُمّ إلى هذا الشهر من الحمل تصبح معرّضة للموت: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كرْها وَوَضَعَتْهُ كرْها [6]﴾.
وليس الحمل فحسب، وإنما تأتي الولادة والحضانة والرعاية. فيأخذ الولد من أبعاد الاُمّ النفسيّة والجسديّة ؛ فيكون بهذا ألصق باُمّه ؛ فلذا يُقدم قولها في حالة التزاحم. فالإخوة لاُمّ يكون بينهم التصاق أكبر عادةً.
يتبع…
____________________
[1] الكافي 2: 275 / 28، مسند الشهاب 2: 302.
[2] المؤمنون: 101.
[3] مناقب آل أبي طالب 3: 291، المزار المشهدي: 141 ـ 142.
[4] وقد يعبّر عنها بقاعدة « التلازم بين النماء والدرك »، أو قاعدة « الخراج بالضمان ». انظر: القواعد الفقهية 6: 308، مئة قاعدة فقهية: 284، المبسوط السرخسي 8: 81، 25: 43، القاموس الفقهي: 278، المعجم القانوني 2: 576. ومعنى القاعدة هو التلازم بين الخسارة والفائدة ؛ فكل من له فائدة المال شرعا عند الربح كان عليه خسارة ذلك المال أيضا.
[5] تنازع رجل يقال له قابس وامرأته هزيلة بنت جديسيان في مولود لهما أراد أبوه أخذه فأبت اُمّه، فارتفعا إلى الملك عمليق، فقالت المرأة: أيها الملك، هذا ابني حملته تسعا ووضعته رفعا وأرضعته شبعا ولم أنل منه نفعا، حتى إذا تمّت أوصاله واستوفى فصاله أراد بعلي أن يأخذه كرها ويتركني ولهى. فقال الرجل: أيها الملك أعطيتها المهر كاملاً ولم اُصب منها طائلاً إلاّ ولدا خاملاً، فافعل ما كنت فاعلاً، على أنني حملته قبل أن تحمله، وكفلت اُمّه قبل أن تكفله. فقالت: أيها الملك، حمله خفّا وحملته ثقلاً، ووضعه شهوة ووضعته كرها.
فلما رأى عمليق متانة حجّتهما، تحيّر فلم يدرِ بم يحكم. معجم البلدان 5: 442. وقد أورد ابن عساكر هذه القصّة بمرافعة أبي الأسود الدؤلي وزوجته لمعاوية. تاريخ مدينة دمشق 52: 202، 70: 269، وفيهما: حمله خفّا وحملته ثقلاً، ووضعه شهوة ووضعته كرها، لم أحمله في غبر، ولم أرضعه غيلاً، فبطني له وعاء وحجري له وقاء.
[6] الأحقاف: 15.