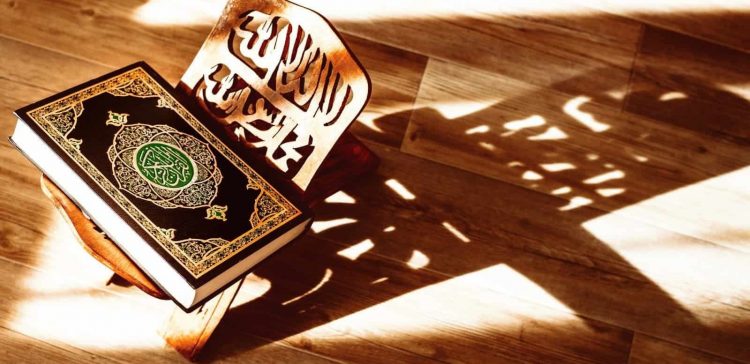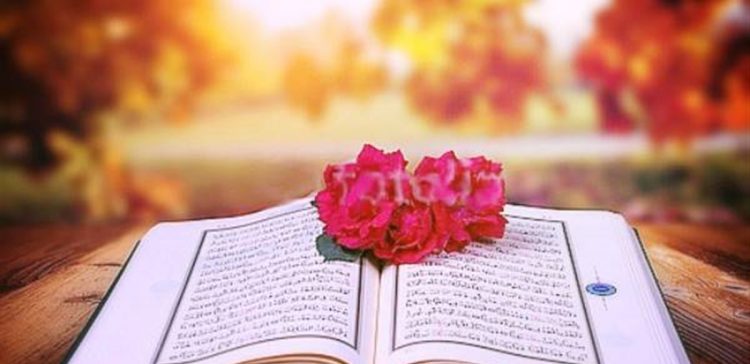شرح دعاء الصباح 27
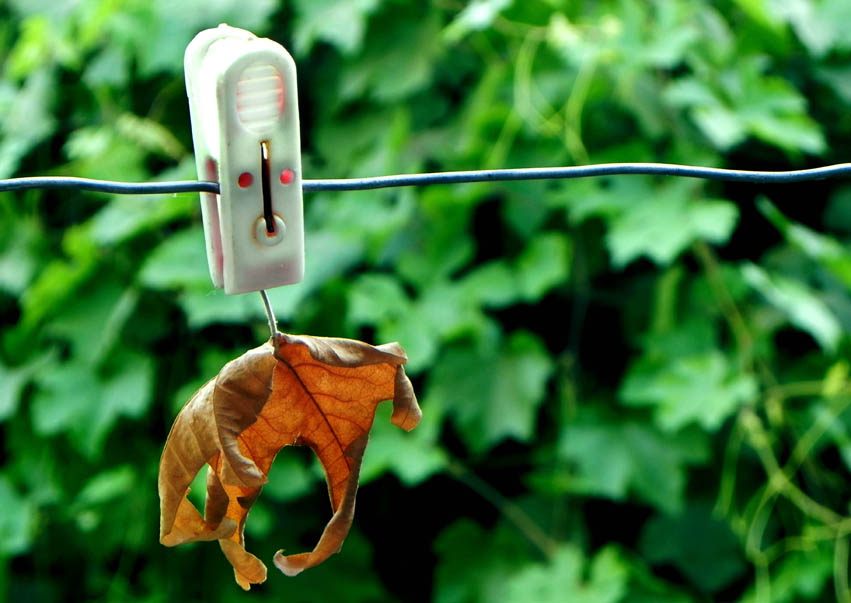
وقوله×: «والعقل وسط الكلّ» تمثيل لكون العقل مركزاً، وهي دوائر، لكن اعلَم أنّ الأمر في المركز والدّائرة المعنويّين في الإحاطة على عكس حال المركز([1]) والدّائرة الحسّيّتين، فذلك العقل الكلّي ـ إن رزقك الله تعالى ـ هو الأصل المحفوظ لهذه.
وروي أيضاً عن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) أنّه سأله أعرابيٌّ عن النّفس، فقال×: «أيّ الأنفس تسأل؟». فقال: يا مولاي، هل النّفس أنفُس عديدة؟ فقال×: «نَفسٌ نامِيَةٌ نَباتِيَّةٌ، وَحِسِّيَّةٌ حَيوانِيَّةٌ، وَناطِقَةٌ قُدْسِيَّةٌ، وَإلهيَّةٌ كُلّيّةٌ مَلَكُوتيّةٌ». قال: يا مولاي، ما النّامية النّباتيّة؟ قال×: «قُوَّةٌ أصلُها الطّبايعُ الأربَعُ ، بَدوُ إيجادها عِندَ مَسقَطِ النُّطفَةِ، مَقّرُّها الكَبدُ، مادَّتُها مِن لَطائِفِ الأغذيّة، فِعلُها النُّمُوُّ والزِّيادة، سَبَبُ اِفتراقِها اِختِلافُ المُتَوَلّداتِ، فَإذا فارَقتْ عادَتْ إلى ما منْهُ بدَت عَودَ مُمازَجَة، لا عَودَ مُجاوَرَة».
فقال: يا مولاي، ما النّفس الحيوانيّة؟ قال× «قُوَّةٌ فَلَكِيَّةٌ وَحَرارَةٌ غَرِيزِيَّةٌ، أصلُها الأفلاكُ، بَدُو إيجادِها عِندَ الوِلادَةِ الجِسمانِيَّةِ، فِعْلُها الحياةُ والحَركةُ والظُّلمُ وَالغَلَبةُ وَاكتِسابُ الشَّهَواتِ الدُّنَيَويِّةِ، مَقَرُّها القَلبُ، سَبَب اِفتِراقِها اختلافُ المُتَولّداتِ، فإذا فارقَتْ عادَتْ إلى ما مِنهُ بَدَتْ عَوْدَ مُمازَجَة لا عَودَ مجاوَرَة، فَتَنْعَدِمُ صُورَتُها، ويَبطُلُ فِعلُها وَوُجودُها، وَيَضَمِحلُّ تُركِيبُها».
فقالَ: ما النّفس النّاطقة القدسيّة؟ قال×: «قُوَّةٌ لاهُوتِيَّةٌ، بدَوُ إيجادِها عِندَ الوَلأدةِ الدُّنيويِّةِ([2])، مَقَرٌّها العُلُومَ الحَقيقيَّةُ، مَوادُّهَا التّأيِيداتُ العقليَّةُ، فِعْلُها المعارِفُ الرَّبانيّة، سَبَبُ فراقِها تَحَلُّل الآلاتِ الجِسمانِيَّةِ، فَإذا فارقَتْ عادَتْ إلى ما مِنهُ بَدتْ عَود مُجاوَرَة لا عودَ مُمازجة».
فقال: ما النّفس الإلهيّة الملكوتيّة الكّليّة؟ فقال×: «قُوَّةٌ لاهُوتَيَّةٌ، وَجَوهَرةٌ بَسِيطَةٌ حَيَّةٌ بالِذّاتِ، أصلُها العَقلُ، مِنهُ بدَتْ وعَنهُ دَعَتْ، وَإليهِ دَلّت وَأشارت، وَعودُها إلَيهِ إذا كَملتْ وَشابَهَتْ، وَمِنها بَدَتِ المَوجُوداتُ، وإليها تَعوُدُ بالِكَمالِ. وَهِيَ ذاتُ العُليا، وَشَجَرةُ طُوبى، وَسِدرةُ المُنتَهى، وَجَنَّةُ الماوى. مَن عَرَفَها لَم يَشقَ أبَداً، وَمَن جَهِلَها ضَلَّ وَغَوى».
فقال السّائل: ما العقل؟ قال×: «جَوهَرٌ درَّاكٌ، مُحيط بِالأشياء عَن جَميعِ جهاتِها، عارِفٌ بِالشّيءِ قَبلَ كَونِهِ، فَهُوَ عِلَّةُ لِلمَوجُوداتِ، وَنهايةُ المطالِب»([3]). صدق وليّ الله.
قوله×: «مقرّها العلوم الحقيقيّة» فيه إشكالٌ على قواعد أرباب العلوم الحقيقيّة؛ إذ قد قُرّر في مقرّه أنّ العلم كيفيّة نفسانيّة، فالنّفس مقرّها دون العكس؛ فلكلامه× بيانان:
أحَدهُما: أن يكون إشارةً إلى اتّحاد العاقل والمعقول على نحو أشرنا إليه سابقاً، وهو أنّ النفس في مقام ذاتها البسيطة جامعة لجميع ما هو معقول بالذّات لها بنحو أعلى، كما أنّها جامعة لجميع قواها بنحو بسيط ومصداق واحد:
|
لَيسَ مِن الله بِمُستنكِر
|
أن يجمَعَ العالَمَ في واحِد([4])
|
فكيف ما في عالم نفس النّفس؟ فالنّفس مقام إجمال تلك المعقولات المفصّلة، ونحو أعلاها. وكلّ كلّي عقليّ إشراقٌ منها، وظهورٌ لها بلا تجافٍ عن مقامها الذّاتي، ومقام تفصيل وشرح للنّفس، كما أنّ كلّ كليٍّ عقليٍّ نورٌ بسيط محيطٌ بالأفراد غير المتناهية، الموضوعة للقضيّة الحقيقيّة، متّحدٌ بها. وهو هي بلا تجافٍ أيضاً؛ فالكلّي العقلي لعظمة وجوده البسيط؛ يسع رداء شموله كلَّ رقائقه؛ ولذلك كلّ ما تناله بقواها من جزئيّات كلّي بعد ذلك لم ينل ذات النّفس أمراً جديداً إلّا ما هو من باب غرائب الطبيعة([5]) وأجانبها. وكذا الكلام في كليّات تلك الغرائب حتّى يؤول إلى الانضمامات الجزئيّة الاعتباريّة. وأمّا الكلّي الطبيعي، فهو أيضاً نفسُ مفهوم، وشيئيّة ماهيّة متّحدة؛ لإبهامها وعدم تحصّلها مع الحقيقة، والرقائق محمولة مواطاة عليهما؛ فالنّفس تظهر بصورة كلّ معرّف في الحدود، ووسط في البراهين وينير([6]) المطالب.
وثانيهما: أن يكون شرحاً لقوله تعالى: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِن أمرِ رَبّي﴾([7]) أي من عالم الأمر لا من عالم الخلق، كالبدن. ومعلوم عند أولي الأمر وأهل الذّكر أنّ أمرَ الله علم الله ومشيئةُ الله، بل النّفس إن كانت من الرّابعة([8]) كانت كسابقتها الحسنى، ولاحقتها المثلى، نفس أمر الله، ومشيئة الله تعالى.
وقوله×: «موادّها التأييدات العقليّة»، لفظ «المادّة» اُطلقت مشاكلة للسّابقتين، أو معرّب «مايه». فإنّ المجرّدات الحقيقيّة «ما هو» فيها «لم هو». ومن قبيل الثاني ما أطلق صدر الدّين القونوي + المادّةَ على وجود الممكن، والصّورةَ على ماهيّته.
وفي كلامه× تصديقٌ تلميحاً لقول الحكماء الإلهيّين حيث يقولون: دركُ الحقائق وحفظها بالاتّصال بالعقل الفعّال، وإنّه خزانة النّفس النّاطقة. قال تعالى: ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى﴾([9]). وذلك لأنّ العقل الفعّال مع وحدته وبساطته اللّائقتَيْنِ به، جامعٌ لجميع صور الحقائق بنحو التجرّد، أو واجد لوجودها بنحو أعلى وأشرف، وهو أحقّ. والنّاطقة يتوجّه إليه ويفيض عليهما صوراً مثل صوره، أو يشاهد نفس الصّور الّتي هناك بلا تعدّد وتكرّر في الصّور، أو يتّحد به ويفنى فيه بلا تعدّد في الموضع:
وَلِلنّاسِ فِيما يَعشِقُونَ مَذاهِبٌ([10])
يتبع…
_____________________________
([1]) أي المركز المعنوي محيطٌ حقّ الإحاطة؛ لأنّها كنقطة مركز راسمة بسيرها مثل الخط والخط المعنوي، كخطّ أُدير على نفسه؛ فيحصل دائرة. ثمّ العقل أيضاً كدائرة مركزه الوجوبُ الذاتيّ. منه.
([2]) يستنبط منه حقيّة كون النّفس جسمانيّة الحدوث، روحانيّة البقاء، حيث قال: «بدو إيجادها» ولم يقل: «بدو تعلّقها». وأيضاً يستنبط من قوله: «فعلها المعارف الرّبانيّة» أن الإدراك بالفعاليّة. منه.
([4]) إرشاد الأذهان 1: 172. التعجب: 60.
([5]) فإذا علمت أنّ النّار مثلاً خفيف مطلقاً، وأنه محرقّ، منضجعّ، معدلّ، خليفة للأنوار العلويّة في الإنارة، إلى غير ذلك من أحكامه، ورأيته في الحال، ولم تره في الماضي والاستقبال فقد أدركت حقيقته، ونلت ما هو أصل ذاته؛ فإنّ تمام الذاتيّ المشترك بين ما في الحال وغيره واحد. وكذا إذا رأيته في موضع فقر، أدركتَ حقيقته التي في الأصقاع والجهات، بحيث لم يبقَ من تمام ذاته شيء. نعم لم تَر انتسابه إلى هذا وذاك من أنّه هل نضج هذا العجين، أو عدل هذا المركّب، أو أنار تلك البقعة أم لا؟ وهذه مطالب القوى الجزئية ومطلوبيّتها بمدخليّة البدن، وكلّ ما هو مطلوبيته ومرغوبيته بمدخلية البدن، فإذا رفضت البدن، زالت مرغوبيته. بخلاف ما هو مطلوب صريح العقل وأعلى المدارك، فإنّه يقوى بعد رفض البدن والغنى عنه وعمّا هو من صقعه مكتفياً بذاته وباطن ذاته. والمعرفة بذر المشاهدة. منه.
([6]) كذا بعطف الفعل على الاسم.
([8]) لأنّ الرابعة فانية في الله، باقية به، فهي كالمعنى الحرفيّ، لا هو ولا غيره. وعلى قول بعض المحققّين: إنه لا ماهية للنّفس الناطقة فضلاً عن النّفس الكليّة الإلهيّة، والعقل الكليّ الذي هو دورها وختمها، فهي نفس الوجود الذي هو كلمة «كُنْ»، وأمر الله التّكويني؛ فكلمة «من» في قوله تعالى: ﴿مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ (الإسراء: 85) على ما ذكر فيما قبل الترقي للتبعيض، وفيما بعده للتّبيين. منه.