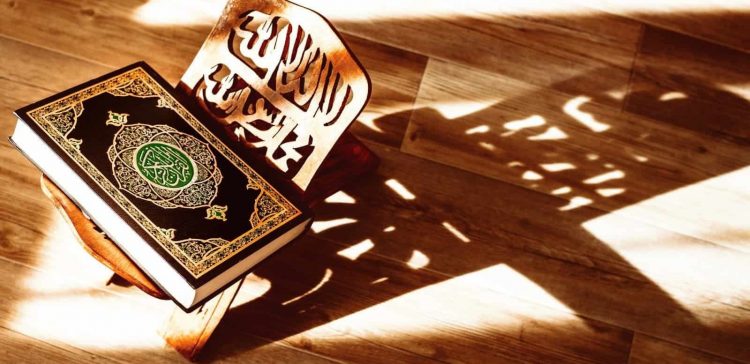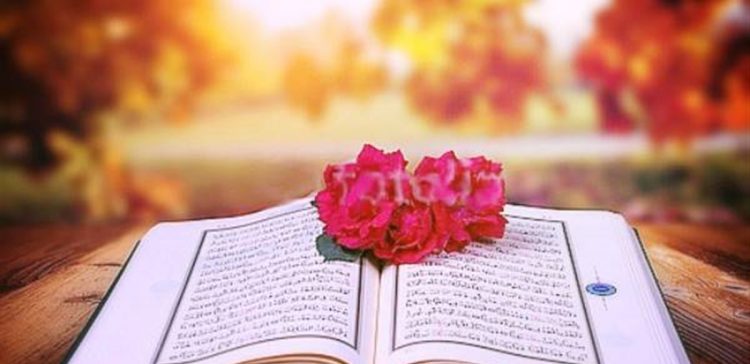شرح دعاء الصباح 9
(9) ﴿وَجلَّ عَن مُلاءَمَةِ كيفيّاتِهِ﴾
«الملاءمة»: الموافقة. و«الكيفيّة»: ما يقال في جواب «كيف هو؟»، كما أنّ «الكميّة» ما يقال في جواب «كم هو؟»، و«الماهيّة» ما يقال في جواب «ما هو؟». ورسم الحكماء «الكيف» بأنّه هيئةٌ قارّة لا تقتضي قسمةً ولا نسبةً. وأقسامُه كثيرة كما هو مقتضى الجمع المضاف. وأقسامُه الأوليّة أربعة:
«الكيفيّات المحسُوسة» المنشعبة بحسب المشاعر الخمسة.
«والنفسانيّة» كالإرادة والقدرة والجبن والشجاعة والفرح والغمّ ونحوها، وبالجملة جميع حالات النّفس ومَلَكاتها.
و«الاستعداديّة».
و«المختصّة بالكمّ».
وكلّها مشروحةٌ في موضعه.
وضمير «كيفيّاته» يمكن أن يعود إلى المخلوق الّذي هو مفرد «مخلوقاته»، والأَولى ألّا يفكّك الضمير ويرجع إلى كلمة «مَنْ([1])»، والإضافة لملابسة المعلوليّة والمملوكيّة لله تعالى. وإنّما جلّ جناب قدسه عن أن يجامعه الكيفيّات؛ لأنّ العرض ليس في مقام وجود موضوعه، وإنّما فيه قوّته، وحامل القوّة هو المادّة، والمادّة لا وجود لها بدون الصّورة، والمركّب منهما جسم؛ تعالى عن الجسميّة علّواً كبيراً.
وأيضاً، لو كان له كيفيّة؛ فإمّا حادثة، فيكون هو تعالى محلّ الحوادث، وإمّا قديمة فيلزم تعدّد القدماء. وفي الحديث: «إنَّ الله لا يُوصَفُ بِالكَيفِ، وكيف أصِفُهُ بِالكَيفِ وَهُوَ الّذي كَيَّفَ الكَيفَ حتى صارَ كَيفاً؟»([2]). ليس المراد من قوله عليه السلام: «كيّف الكيف»([3]) الجعل التركيبيّ([4])؛ لوضوح محاليّته، بل إنّه أوجد الكيف ولكن عبّر به؛ إذ بالوجود يصير كلّ شيء نفسه بالحمل الشّائع. وفي حديث آخر: «ما وَحَّدَهُ مَن كَيَّفَهُ([5])» ([6]) أي من وصفه بكيفيّة فقد ثنّاه. وفي آخر: «كَيفَ أصِفُ رَبّي بِالكَيفُ، والكيف مَخلُوقٌ، وَالله لا يُوصَفُ بِخلقِهِ؟»([7])، ولكن سُئِل الصّادق عليه السلام: ألَهُ كيفيّة؟ قال عليه السلام: «لا؛ لأنّ الكَيفيَّةَ جَهَةُ الضِّيقِ وَالإحاطَةِ، وَلكِن لا بُدَّ مِنَ الخُروُج عَن جهَةِ التَّعطيلِ وَالتَشبيهِ؛ لأنَّ مَن نَفاهُ فَقَد أنكَرَ رُبوبيَّتَهُ وأبطَلَهُ، وَمَن شَبَّهَهُ بِغيرِهِ فَقَد أثَبَتَهُ بِصِفَةِ المَخلُوقيِنَ المصنُوعينَ الَّذِينَ لا يَستَحِقُّونَ الرُّبُوبيِّةَ، وَلِكن لابُدَّ مِن إثباتِ أنَّ لَهُ كَيفيَّة([8]) لا يَستَحِقُّها غَيُرهُ، وَلا يُشارِكُهُ فيها، ولا يُحاطُ بِها، وَلا يَعلَمُها غَيُرهُ»([9]).
أقُول: هذا الحديث مثل فقرة الدّعاء، إشارة إلى أنّ له تعالى صفاتٍ هي عين ذاته، وليس له معانٍ وأحوال زائدة قديمة خلافاً للأشاعرة، ولا حادثة خلافاً للكرّاميّة. قال عليّ عليه السلام: «كَمالُ الإخلاصِ نَفيُ الصِّفاتِ عَنهُ؛ لِشَهادَةِ كُلِّ صِفَة أنَّها غَيرُ الموصُوفِ، وَلِشَهادَةِ كُلِّ مَوصُوف أنَّهُ غَيرُ الصِّفَةِ، فَمَنْ وصفه فَقد قَرَنَةُ، ومَنْ قَرَنَةُ فَقَد ثَنّاهُ»([10]).
________________________________________
([1]) الواردة في صدر الدعاء في قوله عليه السلام: «يا من دلع…».
([3]) الكافي 1: 103 / 12. التوحيد: 61 / 18.
([4]) فإنّ الماهيّة غير مجعولة بالذات بالجعل البسيط، فضلاً عن الجعل المركّب، فما جعل المشمس مشمساً، بل ما جعل ماهيّة المشمس إلاّ بالعرض لجعل وجوده؛ ففاض من الجاعل الحقّ وجوده بالذّات، ثمّ ماهيّته تتبعه في الجعل والتحقّق بالعرض، ثمّ تصدق نفس تلك الماهيّة على نفسها بالعرض لا بالذات؛ لأن الصّدق إيجاب والموجبة تستدعي وجود الموضوع، والمرتبة خالية عن الوجود، فلا تصلح للإيجاب، كالمعدوم بما هو معدوم. منه.
([5]) أي من وصفه بصفة زائدة؛ لأنّه إذا كانت الصفة زائدة على ذاته كانت كيفيّة، فيكون موافقاً لقول عليّ عليه السلام: «فمن وصفه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه»[نهج البلاغة/الخطبة: 1، وفيه: وصف الله]. منه.
([6]) نهج البلاغة / الخطبة: 186.
([7]) بصائر الدرجات: 521 / 1. التوحيد: 310 / 1.
([8]) أي له صفةٌ هي عين ذاته. ومعلوم أنّها لم تكن حينئذٍ معنى قائماً بذاته؛ إذ لا معانيَ في ذاته سوى صريح ذاته، بل هذا مثل ما يقال: الصّفة على الوصف العنوانيّ الذي هو عين الموصوف، ومثل الصفة النفسيّة في لسان المتكلّمين.
وكون الصّفة عين الذات كثيرُ الآيات، كالمعلوم بالذات للصّورة العلميّة، والكلّي لنفس الكليّة، والمتّصل للصّورة الجسميّة، والمضاف للإضافة، والمتقدّم والمتأخر لأجزاء الزّمان، والموجود للوجود الحقيقي، إلى غير ذلك من الموارد. منه.